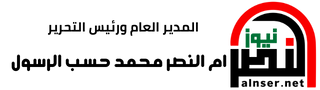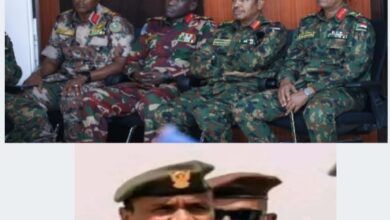“بحور الشوق” هي واحدة من أبهى ما خطه اليراع الشعري الراحل السر دوليب، وغنتها حنجرة إستثنائية هي حنجرة سيد خليفة، الذي إستطاع أن يمنحها حياة أخرى بنبرة صوته وإحساسه الفريد، فتجاوزت حدود النص واللحن لتستقر في وجدان المستمع السوداني كأيقونة من أيقونات العشق والشوق
القصيدة تنفتح على إستعارة عاطفية غامرة من أول سطر، حيث يقول:
(زيدني من دلك شوية وكتر الأشواق عليّا)
كأنما هو رجاء الشوق نفسه حين يطلب المزيد من نار الهوى، لا ليستكين بل ليتوهج أكثر، إستخدام فعل “زيدني” في مخاطبة الحبيب يحمل حالة إستسلام جميلة، ولغة حميمية تنبض بحرارة الوجد، ثم تأتي العبارة الثانية (بكرة قلبك يصفو ليّا) ، فتفتح باب الأمل والتمني بصيغة شعبية محببة، وكأنما الصفاء ينزل من السماء على قلب من تحب !
القصيدة تتقدم بخطى وجدانية ثابتة نحو الأعماق، إذ يصور الشاعر نفسه “مسافر في بحور الشوق”، والمجاز هنا من أبدع ما يكون: فالحب بحر، والاشتياق رحلة، والزّاد فيها ليس طعامًا بل (نظرة وإبتسامات) وهما أقل القليل في المادية، لكنهما كل الكثير في الحب
ثم يرسو على شاطئ الدهشة عند لقاء الحبيب:
“ألقي نفسي بين إيديك وأنسى عيني في عينيك”
هنا التكرار “أنسى” يحمل دلالات فائضة من العشق الذي يفقد صاحبه ذاكرته عن العالم، فكل شيء يتلاشى إلا صورة واحدة تسكن العيون والروح معًا
في المقطع الذي يقول فيه:
(في العيون الحلوة تُهت)
تتحول العيون إلى متاهة وجدانية، والضياع فيها ليس مأساة بل نشوة، أما “الخدود” فهي التي تسلّمت أمر القلب، وهنا مفردة “سلّمت أمري” تستحضر خلفيات جميلة ، كأنما العاشق لا يطلب سوى لمحة من الوصال أو حتى كلمة، ولو كانت (محال)
ثم تأتي قمة الذوبان في قول الشاعر:
“لما إنت تكون معايا ما بفكر في الزمان لا بداية لا نهاية لا الجايي ولا اللي كان”
هي لحظة تجمُّد الزمن، إنفصال العاشق عن كل ما هو دنيوي، ليدخل في دائرة عجيبة لا يُقاس فيها الوقت بالساعات، بل باللحظات العاطفية
هذه الأغنية ليست فقط قصيدة عشق، بل لوحة مكتملة التفاصيل، إستخدم فيها الشاعر السر دوليب مفردات بسيطة، مألوفة، لكنها مكثفة بالتشبيه والاستعارة، ورسم فيها صورة الحبيب في قلب المتلقي، لا عبر وصف مادي، بل عبر الأثر الذي يتركه في روح العاشق
من الناحية الموسيقية، لحّن سيد خليفة هذه القصيدة بعبقرية تنسجم تمامًا مع النص، إذ نجد تنقلات لحنية ناعمة، ومقامات شرقية صرفة تعانق الكلمات بإنسيابية، الموسيقى تبدأ بخفة، تمامًا كما يبدأ الحنين، ثم تتصاعد شيئًا فشيئًا، حتى تبلغ الذروة عند (لما إنت تكون معايا) حيث يبطئ الإيقاع، وتتسع المسافات الصوتية، مما يتيح للمستمع أن يتنفس مع كل كلمة فيها
صوت سيد خليفة هنا، هو صوت (الطلاوة والنداوة) يمتاز بمرونة قلّ نظيرها، قادر على الإنتقال من القرار إلى الجواب دون إفتعال، وصوته في هذه الأغنية تحديدًا يميل إلى الحنان أكثر منه إلى القوة، ما يجعله وعاءً ملائمًا لحمل مشاعر الإنكسار الجميل في القصيدة
هو لا يغني فقط، بل يُحدّثك بالغناء، وتكاد تشعر بأنه لا يؤدي الأغنية لمجرد الأداء، بل يعيشها حتى يخيل إليك أن كلماته إرتجالية خارجة من قلبه في ذات اللحظة
إني من منصتي أستمع …وأقول : في وجدان المستمع السوداني، (بحور الشوق) ليست مجرد عمل فني، إنها مرآة وجدانية، تُستعاد كلما عاد الحنين، وتُردد بصوت منخفض في ليالي الإنتظار الطويل، إنها أغنية “المحب الخجول والمغترب الحنين والحبيبة المشتاقة، هي تلك الأغنية التي يتكئ عليها السوداني حين تضيق به المسافات وتشتد عليه الغربة، فيتوسدها كوسادة من ذكريات عزيزة، لأنها تتكلم لغته، وتبكي بدمعه، وتبتسم بحياء فرحه.